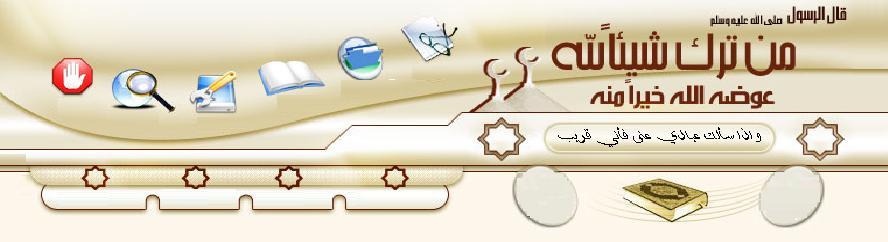الآيتان: 6 - 7 ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور )
قوله تعالى: « ذلك بأن الله هو الحق » لما ذكر افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره واختياره في قوله: « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث - إلى قوله - بهيج » . قال بعد ذلك: « ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور » . فنبه سبحانه وتعالى بهذا على أن كل ما سواه وإن كان موجودا حقا فإنه لا حقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخر مصرف. والحق الحقيقي: هو الموجود المطلق الغني المطلق؛ وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: « وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » [ الحج: 62 ] . والحق الموجود الثابت الذي لا يتغير ولا يزول، وهو الله تعالى. وقيل: ذو الحق على عباده. وقيل: الحق بمعنى في أفعاله. وقال الزجاج: « ذلك » في موضع رفع؛ أي الأمر ما وصف لكم وبين. « بأن الله هو الحق » أي لأن الله هو الحق. وقال: ويجوز أن يكون « ذلك » نصبا؛ أي فعل الله ذلك بأنه هو الحق. « وأنه يحيي الموتى » أي بأنه « وأنه على كل شيء قدير » أي وبأنه قادر على ما أراد. « وأن الساعة آتية » عطف على قوله: « ذلك بأن الله هو الحق » من حيث اللفظ، وليس عطفا في المعنى؛ إذ لا يقال فعل الله ما ذكر بأن الساعة آتية، بل لابد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن الساعة آتية « لا ريب فيها » أي لا شك. « وأن الله يبعث من في القبور » يريد للثواب والعقاب.
الآيات: 8 - 10 ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد )
قوله تعالى: « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » أي نير بين الحجة. نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قال ابن عباس. ( والمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى، فهما في فريق واحد، والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمه وتوبخه: أنت فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصفه في كل آية بزيادة؛ فكأنه قال: إن النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هدى وكتاب منير؛ ليضل عن سبيل الله ) . وهو كقولك: زيد يشتمني وزيد يضربني؛ وهو تكرار مفيد؛ قال القشيري. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. فالمراد بالآية الأولى إنكاره البعث، وبالثانية إنكاره النبوة، وأن القرآن منزل من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر بن الحارث أن الملائكة بنات الله، وهذا جدال في الله تعالى: « من » في موضع رفع بالابتداء. والخبر في قوله: « ومن الناس » . « ثاني عطفه » نصب على الحال. ويتأول على معنيين: أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: ( هو النضر بن الحارث، لوى عنقه مرحا وتعظما ) . والمعنى الآخر: وهو قول الفراء: أن التقدير: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ثاني عطفه، أي معرضا عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال مجاهد وقتادة: لاويا عنقه كفرا. ابن عباس: معرضا عما يدعى إليه كفرا. والمعنى واحد. وروى الأوزاعي عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن عباس في قوله عز وجل: ( « ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله » قال: هو صاحب البدعة. المبرد ) : العطف ما انثنى من العنق. وقال المفضل: والعطف الجانب؛ ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه، أي في جوانبه. وعطفا الرجل من لدن رأسه إلى وركه. وكذلك عطفا كل شيء جانباه. ويقال: ثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك. فالمعنى: أي هو معرض عن الحق في جداله ومول عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى: « ولى مستكبرا كأن لم يسمعها » [ لقمان: 7 ] . وقوله تعالى: « لووا رؤوسهم » [ المنافقون: 5 ] . وقوله: « أعرض ونأى بجانبه » [ الإسراء: 83 ] . وقوله: « ذهب إلى أهله يتمطى » [ القيامة: 33 ] . « ليضل عن سبيل الله » أي عن طاعة الله تعالى. وقرئ « ليضل » بفتح الياء. واللام لام العاقبة؛ أي يجادل فيضل؛ كقوله تعالى: « ليكون لهم عدوا وحزنا » [ القصص: 8 ] . أي فكان لهم كذلك. ونظيره « إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا » [ النحل: 54 - 55 ] . « له في الدنيا خزي » أي هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما قال: « ولا تطع كل حلاف مهين » [ القلم: 10 ] الآية. وقوله تعالى: « تبت يدا أبي لهب وتب » [ المسد: 1 ] . وقيل: الخزي ههنا القتل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبرا؛ كما تقدم في آخر الأنفال. « ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » أي نار جهنم. « ذلك بما قدمت يداك » أي يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصي والكفر. وعبر باليد عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة. و « ذلك » بمعنى هذا، كما تقدم في أول البقرة.
الآية: 11 ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين )
قوله تعالى: « ومن الناس من يعبد الله على حرف » « من » في موضع رفع بالابتداء، والتمام « انقلب على وجهه » على قراءة الجمهور « خسر » . وهذه الآية خبر عن المنافقين. قال ابن عباس: يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما أوحى إليه ارتد شيبة بن ربيعة. وقال أبو سعيد الخدري: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله؛ فتشاءم بالإسلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني! فقال: ( إن الإسلام لا يقال ) فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا! ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: ( يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ) ؛ فأنزل الله تعالى: « ومن الناس من يعبد الله على حرف » . وروى إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( « ومن الناس من يعبد الله على حرف » قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح؛ فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء ) . وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون؛ فإن نالوا رخاء أقاموا، وإن نالتهم شدة ارتدوا. وقيل نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين. ومعنى « على حرف » على شك؛ قاله مجاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حرف مضطرب فيه. وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده؛ ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد. وقيل: « على حرف » أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء؛ ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبدوا الله على حرف. وقيل: « على حرف » على شرط؛ وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره: ادع لي ربك أن يرزقني مالا وإبلا وخيلا وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى؛ ثم أراد الله عز وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: « ومن الناس من يعبد الله على حرف » يريد شرط. وقال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه. وبالجملة فهذا الذي يعبد الله على حرف ليس داخلا بكليته؛ وبين هذا بقوله: « فإن أصابه خير » صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه. « وإن أصابته فتنة » أي خلاف ذلك مما يختبر به. « انقلب على وجهه » أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. « خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهري وابن أبي إسحاق - وروي عن يعقوب - « خاسر الدنيا » بألف، نصبا على الحال، وعليه فلا يوقف على « وجهه » . وخسرانه الدنيا بأن لاحظ في غنيمة ولا ثناء، والآخرة بأن لا ثواب له فيها.
الآية: 12 ( يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد )
قوله تعالى: « يدعو من دون الله » أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي ولا ينفع ولا يضر. « ذلك هو الضلال البعيد » قال الفراء: الطويل.
الآية: 13 ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير )
قوله تعالى: « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » أي هذا الذي انقلب على وجهه يدعو من ضره أدنى من نفعه؛ أي في الآخرة لأنه بعبادته دخل النار، ولم ير منه نفعا أصلا، ولكنه قال: ضره أقرب من نفعه ترفيعا للكلام؛ كقوله تعالى: « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » [ سبأ: 24 ] . وقيل: يعبدونهم توهم أنهم يشفعون لهم غدا كما؛ قال الله تعالى: « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » [ يونس: 18 ] . وقال تعالى: « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [ الزمر: 3 ] . وقال الفراء والكسائي والزجاج: معنى الكلام القسم والتأخير؛ أي يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه. فاللام مقدمه في غير موضعها. و « من » في موضع نصب بـ « يدعو » واللام جواب القسم. و « ضره » مبتدأ. و « أقرب » خبره. وضعف النحاس تأخير الكلام وقال: وليس للام من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير. قلت: حق اللام التقديم وقد تؤخر؛ قال الشاعر:
خالي لأنت ومن جرير خال ينل العلاء ويكرم الأخوالا
أي لخالي أنت؛ وقد تقدم. النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذف؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. قال النحاس: وأحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له، لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب إله، وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش، وهو أحسن ما قيل في الآية عندي، والله أعلم، قال: « يدعو » بمعنى يقول. و « من » مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه.
قلت: وذكر هذا القول القشيري رحمه الله عن الزجاج والمهدوي عن الأخفش، وكمل إعرابه فقال: « يدعو » بمعنى يقول، و « من » مبتدأ، و « ضره » مبتدأ ثان، و « أقرب » خبره، والجملة صلة « من » ، وخبر « من » محذوف، والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه؛ ومثله قول عنترة:
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم
قال القشيري: والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعه؛ ولكن المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: « يا أيها الساحر ادع لنا ربك » [ الزخرف: 49 ] ؛ أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا. وقال الزجاج: يجوز أن يكون « يدعو » في موضع الحال، وفيه هاء محذوفة؛ أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، أي في حال دعائه إياه؛ ففي « يدعو » هاء مضمرة، ويوقف على هذا على « يدعو » . وقوله: « لمن ضره أقرب من نفعه » كلام مستأنف مرفوع بالابتداء، وخبره « لبئس المولى » وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أول الكلام. قال الزجاج: ويجوز أن يكون « ذلك » بمعنى الذي، ويكون في محل النصب بوقوع « يدعو » عليه؛ أي الذي هو الضلال البعيد يدعو؛ كما قال: « وما تلك بيمنك يا موسى » أي ما الذي. ثم قوله « لمن ضره » كلام مبتدأ، و « لبئس المولى » خبر المبتدأ؛ وتقدير الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد؛ قدم المفعول وهو الذي؛ كما تقول: زيدا يضرب؛ واستحسنه أبو علي. وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول؛ وأنشد:
عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق
أي والذي. وقال الزجاج أيضا والفراء: يجوز أن يكون « يدعو » مكررة على ما قبلها، على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء، ولا تعديه إذ قد عديته أولا؛ أي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زيدا ضربت، ثم حذفت يدعو الآخرة اكتفاء بالأولى. قال الفراء: ويجوز « لمن ضره » بكسر اللام؛ أي يدعو إلى من ضره أقرب من نفعه، قال الله عز وجل: « بأن ربك أوحى لها » أي إليها. وقال الفراء أيضا والقفال: اللام صلة؛ أي يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبده. وكذلك هو في قراءة عبدالله بن مسعود. « لبئس المولى » أي في التناصر « ولبئس العشير » أي المعاشر والصاحب والخليل. مجاهد: يعني الوثن.
الآية: 14 ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد )
قوله تعالى: « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين في الآخرة أيضا. « إن الله يفعل ما يريد » أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء؛ فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضله، وللكافرين النار بما سبق من عدله؛ لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيد.
الآية: 15 ( من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ )
قوله تعالى: « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء » قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه. « فليمدد بسبب إلى السماء » أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء. « ثم ليقطع » أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له « فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » وحيلته ما يغيظه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. وكذا قال ابن عباس: ( إن الكناية في « ينصره الله » ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه؛ لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم ومن يعبد الله على حرف أنا لا ننصر محمدا فليفعل كذا وكذا ) . وعن ابن عباس أيضا ( أن الهاء تعود على « من » والمعنى: من كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق، فليقتل نفسه؛ إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله ) . والنصر على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله؛ أي من أعطاني أعطاه الله. ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة؛ أي ممطورة. قال الفقعسي:
وإنك لا تعطي امرأ فوق حقه ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره
وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: « من كان يظن أن لن ينصره الله » أي لن يرزقه. وهو قول أبي عبيدة. وقيل: إن الهاء تعود على الدين؛ والمعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله دينه. « فليمدد بسبب » أي بحبل. والسبب ما يتوصل به إلى الشيء. « إلى السماء » إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة. وقرأ الكوفيون « ثم ليقطع » بإسكان اللام. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية؛ لأن « ثم » ليست مثل الواو والفاء، لأنها يوقف، عليها وتنفرد. وفي قراءة عبدالله « فليقطعه ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظه » . قيل: « ما » بمعنى الذي؛ أي هل يذهبن كيده الذي يغيظه، فحذف الهاء ليكون أخف. وقيل: « ما » بمعنى المصدر؛ أي هل يذهبن كيده غيظه.