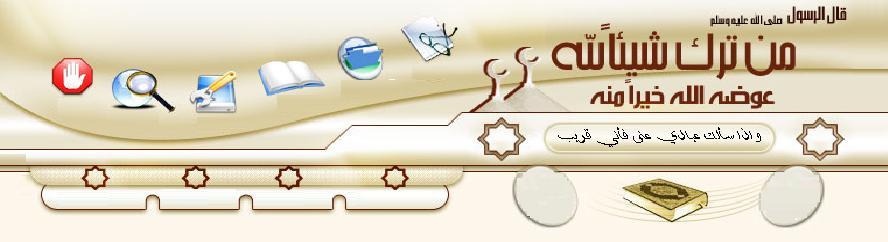الآية: 104 ( وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين )
قوله تعالى: « وما تسألهم عليه من أجر » « من » صلة؛ أي ما تسألهم جعلا. « إن هو » أي ما هو؛ يعني القرآن والوحي. « إلا ذكر » أي عظة وتذكرة « للعالمين » .
الآية: 105 ( وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون )
قال الخليل وسيبويه: هي « أي » دخل عليها كاف التشبيه وبنيت معها، فصار في الكلام معنى كم، وقد مضى في « آل عمران » القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية « السماوات والأرض » في « البقرة » . وقيل: الآيات آثار عقوبات الأمم السالفة؛ أي هم غافلون معرضون عن تأمل. وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد « والأرض » رفعا ابتداء، وخبره. « يمرون عليها » . وقرأ السدي « والأرض » نصبا بإضمار فعل، والوقف على هاتين القراءتين على « السماوات » . وقرأ ابن مسعود: « يمشون عليها » .
الآية: 106 ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )
قوله تعالى: « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها، وهم يعبدون الأوثان؛ قاله الحسن، ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين. وقال عكرمة هو قوله: « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » [ الزخرف: 87 ] ثم يصفونه بغير صفته ويجعلون له أندادا؛ ودعن الحسن أيضا: أنهم أهل كتاب معهم شرك وإيمان، آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا يصح إيمانهم؛ حكاه ابن، الأنباري. وقال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وعنه أيضا أنهم النصارى. وعنه أيضا أنهم المشبهة، آمنوا مجملا وأشركوا مفصلا. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى: « وما يؤمن أكثرهم بالله » أي باللسان إلا وهو كافر بقلبه؛ ذكره الماوردي عن الحسن أيضا. وقال عطاء: هذا في الدعاء؛ وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء؛ بيانه: « وظنوا أنهم أحيط بهم » [ يونس: 22 ] الآية. وقوله: « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه » [ يونس: 12 ] الآية. وفي آية أخرى: « وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: 51 ] . وقيل: معناها أنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا؛ فيجعلون. نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب.
قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل: نزلت هذه الآية في قصة الدخان؛ وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان في سني القحط قالوا: « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » [ الدخان: 12 ] فذلك إيمانهم، وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب؛ بيانه قوله: « إنكم عائدون » [ الدخان: 15 ] والعود لا يكون إلا بعد ابتداء؛ فيكون معنى: « إلا وهم مشركون » أي إلا وهم عائدون إلى الشرك، والله أعلم.
الآية: 107 ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون )
قوله تعالى: « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » قال ابن عباس: مجللة. وقال مجاهد: عذاب يغشاهم؛ نظيره. « يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » [ العنكبوت: 55 ] . وقال قتادة: وقيعة تقع لهم. وقال الضحاك: يعني الصواعق والقوارع. « أو تأتيهم الساعة » يعني القيامة. « بغتة » نصب على الحال؛ وأصله المصدر. وقال المبرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أمر بغتة وفجأة؛ قال النحاس: ومعنى « بغتة » إصابة من حيث لم يتوقع. « وهم لا يشعرون » وهو توكيد. وقوله: « بغتة » قال ابن عباس: تصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم، كما قال: « تأخذهم وهم يخصمون » [ يس: 49 ] على ما يأتي.
الآية: 108 ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )
قوله تعالى: « قل هذه سبيلي » ابتداء وخبر؛ أي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنهاجي؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع: دعوتي، مقاتل: ديني، والمعنى واحد؛ أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة. « على بصيرة » أي على يقين وحق؛ ومنه: فلان مستبصر بهذا. « أنا » توكيد. « ومن اتبعني » عطف على المضمر. « وسبحان الله » أي قل يا محمد: « وسبحان الله » . « وما أنا من المشركين » الذين يتخذون من دون الله أندادا.
الآية: 109 ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون )
قوله تعالى: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى » هذا رد على القائلين: « لولا أنزل عليه ملك » [ الأنعام: 8 ] أي أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا جني ولا ملك؛ وهذا يرد ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم ) . وقد تقدم في « آل عمران » شيء من هذا. « من أهل القرى » يريد المدائن؛ ولم يبعث الله نبيا من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء، ولا من الجن. وقال قتادة: « من أهل القرى » أي من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم وأحلم. وقال العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا؛ وإنما قالوا آدميا تحرزا؛ من قوله: « يعوذون برجال من الجن » [ الجن: 6 ] والله أعلم.
قوله تعالى: « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا » إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم فيعتبروا. « ولدار الآخرة خير » ابتداء وخبره. وزعم الفراء أن الدار هي الآخرة؛ وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ، كيوم الخميس، وبارحة الأولى؛ قال الشاعر:
ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين
أي عرفانا يقينا؛ واحتج الكسائي بقولهم: صلاة الأولى؛ واحتج الأخفش بمسجد الجامع. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليتعرف به؛ والأجود الصلاة الأولى، ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند صلاة الفريضة الأولى؛ وإنما سميت الأولى لأنها أول ما صلي حين فرضت الصلاة، وأول ما أظهر؛ فلذلك قيل لها أيضا الظهر. والتقدير: ولدار الحال الآخرة خير، وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار الجنة؛ أي هي خير للمتقين. وقرئ: « وللدار الآخرة » . وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم. « أفلا تعقلون » بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر.
الآية: 110 ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين )
قوله تعالى: « حتى إذا استيأس الرسل » تقدم القراءة فيه ومعناه. « وظنوا أنهم قد كذبوا » وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم. وهذا الباب عظيم، وخطره جسيم، ينبغي الوقوف، عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا ثم لم نعاقب أممهم بالعذاب. « حتى إذا استيأس الرسل » أي يئسوا من إيمان قومهم. « وظنوا أنهم قد كذبوا » بالتشديد؛ أي أيقنوا أن قومهم كذبوهم. وقيل المعنى: حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كذبوهم، لا أن القوم كذبوا، ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذبونهم؛ أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك؛ فيكون « وظنوا » على بابه في هذا التأويل. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو عبدالرحمن السلمي وأبو جعفر بن القعقاع والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعمش وخلف « كذبوا » بالتخفيف؛ أي ظن القوم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب، ولم يصدقوا. وقيل: المعنى ظن الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم. وفي رواية عن ابن عباس؛ ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل: لم تصح هذه الرواية؛ لأنه لا يظن بالرسل هذا الظن، ومن ظن هذا الظن لا يستحق النصر؛ فكيف قال: « جاءكم نصرنا » ؟ ! قال القشيري أبو نصر: ولا يبعد إن صحت الرواية أن المراد خطر بقلوب الرسل هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: ( إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل به ) . ويجوز أن يقال: قربوا من ذلك الظن؛ كقولك: بلغت المنزل، أي قربت منه.
وذكر الثعلبي والنحاس عن ابن عباس قال: كانوا بشرا فضعفوا من طول البلاء، ونسوا وظنوا أنهم أخلفوا؛ ثم تلا: « حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » [ البقرة: 214 ] . وقال الترمذي الحكيم: وجهه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصر، لا من تهمة لوعد الله، ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت، حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. وقال المهدوي عن ابن عباس: ظنت الرسل أنهم قد أخلفوا على ما يلحق البشر؛ واستشهد بقول إبراهيم عليه السلام: « رب أرني كيف تحيى الموتى » [ البقرة: 260 ] الآية. والقراءة الأولى أولى. وقرأ مجاهد وحميد - « قد كذبوا » بفتح الكاف والذال مخففا؛ على معنى: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا، لما رأوا من تفضل الله عز وجل في تأخير العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولما أيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم جاء الرسل نصرنا. وفي البخاري عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل: « حتى إذا استيأس الرسل » قال قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل! لعمري! لقد استيقنوا بذلك؛ فقلت لها: « وظنوا أنهم قد كذبوا » قالت: معاذ الله! لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. وفي قوله تعالى: « جاءهم نصرنا » قولان: أحدهما: جاء الرسل نصر الله؛ قال مجاهد. الثاني: جاء قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. « فننجي من نشاء » قيل: الأنبياء ومن آمن معهم. وروي عن عاصم « فنجي من نشاء » بنون واحدة مفتوحة الياء، و « من » في موضع رفع، اسم ما لم يسم فاعله؛ واختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها في مصحف عثمان، وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة. وقرأ ابن محيصن « فنجا » فعل ماض، و « من » في موضع رفع لأنه الفاعل، وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول. « ولا يرد بأسنا » أي عذابنا. « عن القوم المجرمين » أي الكافرين المشركين.
الآية: 111 ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )
قوله تعالى: « لقد كان في قصصهم عبرة » أي في قصة يوسف وأبيه وإخوته، أو في قصص الأمم. « عبرة » أي فكرة وتذكرة وعظة. « لأولي الألباب » أي العقول. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: إن يعقوب عاش مائة سنة وسبعا وأربعين سنة، وتوفي أخوه عيصو معه في يوم واحد، وقبرا في قبر واحد؛ فذلك قوله: « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » إلى آخر السورة. « ما كان حديثا يفترى » أي ما كان القرآن حديثا يفترى، أو ما كانت هذه القصة حديثا يفترى. « ولكن تصديق الذي بين يديه » أي ولكن كان تصديق، ويجوز الرفع بمعنى لكن هو تصديق الذي بين يديه أي ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى؛ وهذا تأويل من زعم أنه القرآن. « وتفصيل كل شيء » مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام، والشرائع والأحكام. « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » .