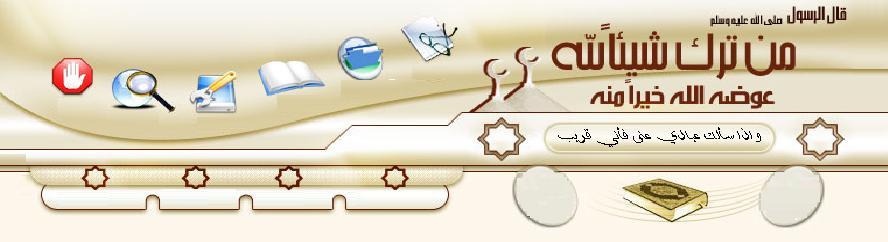الآية: 34 ( قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون )
قوله تعالى: « قل هل من شركائكم » أي آلهتكم ومعبوداتكم. « من يبدأ الخلق ثم يعيده » أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلا فـ « قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده » وليس غيره يفعل ذلك. « فأنى تؤفكون » أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل.
الآية: 35 ( قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يَهِدِّي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون )
قوله تعالى: « قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق » يقال: هداه للطريق وإلى الطريق بمعنى واحد؛ وقد تقدم. أي هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام؛ فإذا قالوا لا ولا بد منه فـ « قل » لهم « الله يهدي للحق » ثم قل لهم موبخا ومقررا. « أفمن يهدي » أي يرشد. « إلى الحق » وهو الله سبحانه وتعالى. « أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر:
للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا.
وفي « يهدي » قراءات ست: الأولى: قرأ أهل المدينة إلا ورشا « يَهْدِّي » بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: « لا تعْدُّوا » وفي قوله: « يخْصِّمون » . قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسر، وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة. الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان، على مذهبه في الإخفاء والاختلاس. الثالثة: قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن « يَهَدِّي » بفتح الياء والهاء وتشديد الدال، قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية، والأصل فيها يهتدى أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها على الهاء. الرابعة: قرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير، إلا أنهم كسروا الهاء، قالوا: لأن الجزم إذا اضطر إلى حركته حرك إلى الكسر. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى مضر. الخامسة: قرأ أبو بكر عن عاصم يِهِدِّي بكسر الياء والهاء وتشديد الدال، كل ذلك لاتباع الكسر كما تقدم في البقرة في « يخطف » [ البقرة: 20 ] وقيل: هي لغة من قرأ « نستعين » ، و « لن تمسنا النار » ونحوه. وسيبويه لا يجيز « يهدي » ويجيز « تهدي » و « نهدي » و « اهدي » قال: لأن الكسرة في الياء تثقل. السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش « يَهْدِي » بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من هدى يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية وإن كانت بعيدة، وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قالا: « يهدي » بمعنى يهتدي. قال أبو العباس: لا يعرف هذا، ولكن التقدير أمن لا يهدي غيره، ثم الكلام، ثم قال: « إلا أن يهدى » استأنف من الأول، أي لكنه يحتاج أن يهدى؛ فهو استثناء منقطع، كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع، أي لكنه يحتاج أن يسمع. وقال أبو إسحاق: « فما لكم » كلام تام، والمعنى: فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم: « كيف تحكمون » أي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح، تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئا إلا أن يفعل بها، والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛ فموضع « كيف » نصب بـ « تحكمون » .
الآية: 36 ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون )
قوله تعالى: « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في أنها آلهة وأنها تشفع، ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا. « إن الظن لا يغني من الحق شيئا » أي من عذاب الله؛ فالحق هو الله. وقيل « الحق » هنا اليقين؛ أي ليس الظن كاليقين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد. « إن الله عليم بما يفعلون » من الكفر والتكذيب، خرجت مخرج التهديد.
الآية: 37 ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين )
قوله تعالى: « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » « أن » مع « يفترى » مصدر، والمعنى: وما كان هذا القرآن افتراء؛ كما تقول: فلان يحب أن يركب، أي يحب الركوب، قاله الكسائي. وقال الفراء: المعنى وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى؛ كقوله: « وما كان لنبي أن يغل » [ آل عمران: 161 ] « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » [ التوبة: 122 ] . وقيل: « أن » بمعنى اللام، تقديره: وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل: بمعنى لا، أي لا يفترى. وقيل: المعنى ما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم ينسبه إلى الله تعالى لإعجازه؛ لوصفه ومعانيه وتأليفه. « ولكن تصديق الذي بين يديه » قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن كان تصديق؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى: ولكن هو تصديق. « الذي بين يديه » أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، فإنها قد بشرت به فجاء مصدقا لها في تلك البشارة، وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة. وقيل: المعنى ولكن تصديق النبي بين يدي القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا منه القرآن. « وتفصيل » بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق. والتفصيل التبيين، أي يبين ما في كتب الله المتقدمة. والكتاب اسم الجنس. وقيل: أراد بتفصيل الكتاب ما بين في القرآن من الأحكام. « لا ريب فيه » الهاء عائدة للقرآن، أي لا شك فيه أي في نزول من قبل الله تعالى.
الآية: 38 ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين )
قوله تعالى: « أم يقولون افتراه » أم ههنا في موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت بما قبلها. وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: « الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه » [ السجدة: 1، 2، 3 ] أي بل أيقولون افتراه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو، مجازة: ويقولون افتراه. وقيل: الميم صلة، والتقدير: أيقولون افتراه، أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، فهو استفهام معناه التقريع. « قل فأتوا بسورة مثله » ومعنى الكلام الاحتجاج، فإن الآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله؛ لأنه مصدق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم محمد عليه السلام عن أحد. وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن، وأنه معجز في مقدمة الكتاب، والحمد لله.
الآية: 39 ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين )
قوله تعالى: « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » أي كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه وتفسيره، وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب أن ينظر في التأويل. وقوله: « ولما يأتهم تأويله » أي ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم. أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولم يأتهم تأويله أي حقيقة ما وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن ( من جهل شيئا عاداه ) قال نعم، في موضعين: « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وقوله: « وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » [ الأحقاف: 11 ] . « كذلك كذب الذين من قبلهم » يريد الأمم الخالية، أي كذا كانت سبيلهم. والكاف في موضع نصب. « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » أي أخذهم بالهلاك والعذاب.
الآية: 40 ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين )
قوله تعالى: « ومنهم من يؤمن به » قيل: المراد أهل مكة، أي ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعداء. و « من » رفع بالابتداء والخبر في المجرور. وكذا. « ومنهم من لا يؤمن به » والمعنى ومنهم من يصر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد أهل الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح. وقيل. إن الضمير في « به » يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ فأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن. « وربك أعلم بالمفسدين » أي من يصر على كفره؛ وهذا تهديد لهم.
الآية: 41 ( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون )
قوله تعالى: « وإن كذبوك فقل لي عملي » رفع بالابتداء، والمعنى: لي ثواب عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى. « ولكم عملكم » أي جزاؤه من الشرك. « أنتم بريؤون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » مثله؛ أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. وهذه الآية منسوخة بآية السيف؛ في قول مجاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد.
الآية [ 42 ] في الصفحة التالية ...