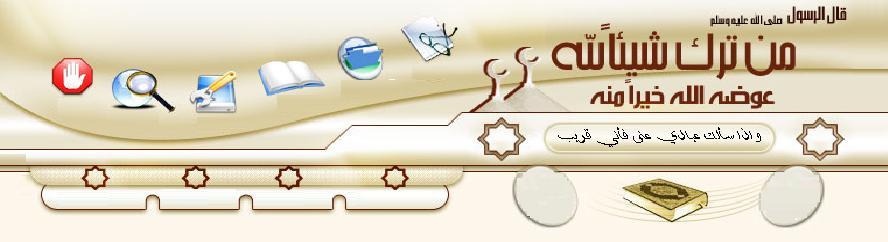الآية: 26 ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون )
قوله تعالى: « واذكروا إذ أنتم قليل » قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. « مستضعفون » نعت. « في الأرض » أي أرض مكة. « تخافون » نعت. « أن يتخطفكم » في موضع نصب. والخطب: الأخذ بسرعة. « الناس » رفع على الفاعل. قتادة وعكرمة: هم مشركو قريش. وهب بن منبه: فارس والروم. « فآواكم » قال ابن عباس: إلى الأنصار. السدي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد. أوى إليه ( بالمد ) : ضم إليه. وأوى إليه ( بالقصر ) : انضم إليه. « وأيدكم » قواكم. « بنصره » أي بعونه. وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة يوم بدر. « من الطيبات » أي الغنائم. « لعلكم تشكرون » قد تقدم معناه.
الآية: 27 ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )
روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبدالمنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت هذه الآية. فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سواري المسجد، وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت، أو يتوب الله علي. الخبر مشهور. وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فيمن كان عنده من الناس؛ فلما انتهى إليهم وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل عليهما السلام؛ فقلت: هذا دحية يا رسول الله ؟ فقال: « هذا جبريل عليه السلام » . قال: « يا رسول الله ما يمنعك من بني قريظة أن تأتيهم ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » فكيف لي بحصنهم « ؟ فقال جبريل: » فإني أدخل فرسي هذا عليهم « . فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معروري؛ فلما رآه علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا عليك ألا تأتيهم، فإنهم يشتمونك. فقال: » كلا إنها ستكون تحية « . فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا إخوة القردة والخنازير ) فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فحاشا! فقالوا: لا ننزل على حكم محمد، ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » بذلك طرقني الملك سحرا « . فنزل فيهم » يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون « . نزلت في أبي لبابة، أشار إلى بني قريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، لا تفعلوا فإنه الذبح، وأشار إلى حلقه. وقيل: نزلت الآية في أنهم يسمعون الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم فيلقونه إلى المشركين ويفشونه. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو الذي أمر بقسمتها. وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المؤدي عن الله عز وجل والقيم بها. والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: » يعلم خائنة الأعين « [ غافر: 19 ] وكان عليه السلام يقول: ( اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ) . خرجه النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ فذكره. » وتخونوا أماناتكم « في موضع جزم، نسقا على الأول. وقد يكون على الجواب؛ كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والأمانات: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. وقد تقدم في » النساء « القول في أداء الأمانات والودائع وغير ذلك. » وأنتم تعلمون « أي ما في الخيانة من القبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة.»
الآية: 28 ( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم )
قوله تعالى: « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » كان لأبي لبابة أموال وأولاد في بني قريظة: وهو الذي حمله على ملاينتهم؛ فهذا إشارة إلى ذلك. « فتنة » أي اختبار؛ امتحنهم بها. « وأن الله عنده أجر عظيم » فآثروا حقه على حقكم.
الآية: 29 ( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم )
قد تقدم معنى « التقوى » . وكان الله عالما بأنهم يتقون أم لا يتقون. فذكر بلفظ الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا. فإذا اتقى العبد ربه - وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه - وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وشحن قلبه بالنية الخالصة، وجوارحه بالأعمال الصالحة، وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمال، والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال، جعل له بين الحق والباطل فرقانا، ورزقه فيما يريد من الخير إمكانا. قال ابن وهب: سألت مالكا عن قوله سبحانه وتعالى: « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » قال: مخرجا، ثم قرأ « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » [ الطلاق: 2 ] . وحكى ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواء، وقاله مجاهد قبله. وقال الشاعر:
مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا
وقال آخر:
وكيف أرجي الخلد والموت طالبي وما لي من كأس المنية فرقان
ابن إسحاق: « فرقانا » فصلا بين الحق والباطل؛ وقال ابن زيد. السدي: نجاة. الفراء: فتحا ونصرا. وقيل: في الآخرة، فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار النار.
الآية: 30 ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة؛ فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه، ورصدوه على باب منزل طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ودعا الله عز وجل أن يعمى عليهم أثره، فطمس الله على أبصارهم، فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع على رؤوسهم ترابا ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أن ليس في الدار أحد، فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها. ومعنى « ليثبتوك » ليحبسوك؛ يقال: أثبته إذا حبسته. وقال قتادة: « ليثبتوك » وثاقا. وعنه أيضا وعبدالله بن كثير: ليسجنوك. وقال أبان بن تغلب وأبو حاتم: ليثخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال الشاعر:
فقلت ويحكما ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا
« أو يقتلوك أو يخرجوك » عطف. « ويمكرون » مستأنف. والمكر: التدبير في الأمر في خفية. « والله خير الماكرين » خير « ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون.»
الآية: 31 ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين )
نزلت في النضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الحيرة في التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة، وكسرى وقيصر؛ فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار من مضى قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذا. وكان هذا وقاحة وكذبا. وقيل: إنهم توهموا أنهم يأتون بمثله، كما توهمت سحرة موسى، ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا: إن هذا إلا أساطير الأولين. وقد تقدم.
الآية: 32 ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم )
القراء على نصب « الحق » على خبر ( كان ) . ودخلت ( هو ) للفصل. ويجوز ( هو الحق ) بالرفع. « من عندك » قال الزجاج: ولا أعلم أحدا قرأ بها. ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها ولكن القراءة سنة، لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبير: قائل هذا هو النضر بن الحارث. أنس بن مالك: قائله أبو جهل؛ رواه البخاري ومسلم. ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم، أو على وجه العناد والإبهام على الناس أنهم على بصيرة، ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. حكي أن ابن عباس لقيه رجل من اليهود؛ فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية. فهلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيلي، من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه، وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا: « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » [ الأعراف: 138 ] فقال لهم موسى: « إنكم قوم تجهلون » [ الأعراف: 138 ] فأطرق اليهودي مفحما. « فأمطر » أمطر في العذاب. ومطر في الرحمة؛ عن أبي عبيدة. وقد تقدم.
الآية: 33 ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )
لما قال أبو جهل: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية، نزلت « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » كذا في صحيح مسلم. وقال ابن عباس: لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها والمؤمنون؛ يلحقوا بحيث أمروا. « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: غفرانك. والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره؛. قاله الضحاك وغيره. وقيل: إن الاستغفار هنا يراد به الإسلام. أي « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » أي يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقيل: « وهم يستغفرون » أي في أصلابهم من يستغفر الله. روي عن مجاهد أيضا. وقيل: معنى « يستغفرون » لو استغفروا. أي لو استغفروا لم يعذبوا. استدعاهم إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه، لم يكن يتحرج؛ فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ورجع عما كان عليه، وأظهر الدين والنسك. فقيل له: لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك. قال: كان لي أمانان، فمضى واحد وبقي الآخر؛ قال الله تبارك وتعالى: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فهذا أمان. والثاني « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » .