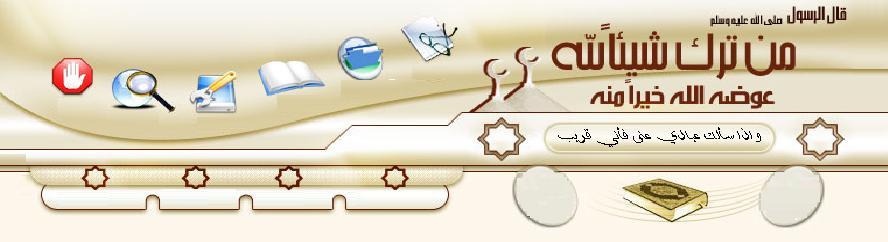لآيات:43 - 45 ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين )
قوله تعالى: « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » ( لولا ) تخصيص، وهي التي تلي الفعل بمعنى هلا؛ وهذا عتاب على ترك الدعاء، وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص، أو تضرعوا حين لابسهم العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور ب حال الرخاء والشدة؛ قال الله تعالى: « ادعوني استجب لكم » [ غافر: 60 ] وقال: « إن الذين يستكبرون عن عبادتي » [ غافر: 60 ] أي دعائي « سيدخلون جهنم داخرين » [ غافر: 60 ] وهذا وعيد شديد. « ولكن قست قلوبهم » أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية، نسأل الله العافية. « وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها.
قوله تعالى: « فلما نسوا ما ذكروا به » يقال: لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ فالجواب: أن ( نسوا ) بمعنى تركوا ما ذكروا به، عن ابن عباس وابن جريج، وهو قول أبي علي؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي، كما يقال: تركه. في النسي. جواب آخر: وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك؛ كما جاز الذم على التعرض لسخط الله عز وجل وعقابه. « فتحنا عليهم أبواب كل شيء » أي من النعم والخيرات، أي كثرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم. « حتى إذا فرحوا بما أوتوا » معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضاء الله عز وجل عنهم « أخذناهم بغتة » أي استأصلناهم وسطونا بهم. و ( بغتة ) معناه فجأة، وهي الأخذ على غرة ومن غير تقدم أمارة؛ فإذا أخذ لإنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء ما يفجأ من البغت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف - فأعرضوا عنه - قام مقام الإمارة. والله أعلم. و ( بغتة ) مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدم؛ فكان ذلك استدراجا من الله تعالى كما قال: « وأملي لهم إن كيدي متين » [ الأعراف: 183 ] نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبدا تدبر هذه الآية « حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة » . وقال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم ) ثم تلا « فلما نسوا ما ذكروا به » الآية كلها. وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخفف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه وسلم: ( إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل ذنب عجلت عقوبته ) .
قوله تعالى: « فإذا هم مبلسون » المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج:
يا صاح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرفه وأبلسا
أي تحير لهول ما رأى، ومن ذلك اشتق اسم إبليس؛ أبلس الرجل سكت، وأبلست الناقة وهي مبلاس إذا لم ترغ من شدة الضبعة؛ ضبعت الناق تضبع ضبعة وضبعا إذا أرادت الفحل.
قوله تعالى: « فقطع دابر القوم الذين ظلموا » الدابر الآخر؛ يقال: دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود ( من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريا ) أي في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية. قال قطرب: يعني أنهم استؤصلوا وأهلكوا. قال أمية بن أبي الصلت:
فأهلكوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا
ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور.
قوله تعالى: « والحمد لله رب العالمين » قيل: على إهلاكهم وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر، إلى العذاب الدائم، مع استحقاق القاطع الحمد من كل حامد.
الآية: 46 - 47 ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون )
قوله تعالى: « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم » أي أذهب وانتزع. ووحد « سمعكم » لأنه مصدر يدل على الجمع. « وختم » أي طبع. وجواب ( إن ) محذوف تقديره: فمن يأتيكم به، وموضعه نصب؛ لأنها في موضع الحال، كقولك: اضربه إن خرج أي خارجا. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه الجوارح، وقد يذهب الله الجوارح والأعراض جميعا فلا يبقي شيئا، قال الله تعالى: « من قبل أن نطمس وجوها » [ النساء: 47 ] والآية احتجاج على الكفار. « من إله غير الله يأتيكم به » « من » رفع بالابتداء وخبرها « إله » و « غيره » صفة له، وكذلك « يأتيكم » موضعه رفع بأنه صفة « إله » ومخرجها مخرج الاستفهام، والجملة التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم. ومعنى « أرأيتم » علمتم؛ ووحد الضمير في ( به ) - وقد تقدم الذكر بالجمع - لأن المعنى أي بالمأخوذ، فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على السمع بالتصريح؛ مثل قوله: « والله ورسوله أحق أن يرضوه » [ التوبة: 62 ] . ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين. وقيل: « من إله غير الله يأتيكم » . بأحد هذه المذكورات. وقيل: على الهدى الذي تضمنه المعنى.
وقرأ عبدالرحمن الأعرج ( به انظر ) بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش: في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمته هنا وفي غير آية، وقد مضى هذا في أول « البقرة » مستوفى. وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. « ثم هم يصدفون » أي يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف. وصادفته مصادفة أي لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال ابن الرقاع:
إذا ذكرن حديثا قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقى صدف
والصدف في البعير أن يميل خفه من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي؛ فهم يصدفون أي مائلون معرضون عن الحجج والدلالات.
قوله تعالى: « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » الحسن: « بغتة » ليلا « أو جهرة » نهارا. وقيل: بغتة فجأة. وقال الكسائي: يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتا وبغتة إذا أتاهم فجأة، وقد تقدم. « هل يهلك إلا القوم الظالمون » نظيره « فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » [ الأحقاف: 35 ] أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم؛ والظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه: « يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » [ لقمان: 13 ] .
الآية: 48 ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون )
قوله تعالى: « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » أي بالترغيب والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك قوله تعالى: « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » [ الأعراف: 96 ] . ومعنى ( منذرين ) مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنما أرسلنا المرسلين لهذا لا لما يقترح عليهم من الآيات، وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم. وقوله: « فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . تقدم القول فيه.
الآية: 49 ( والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون )
قوله تعالى: « والذين كذبوا بآياتنا » أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد عليه الصلاة والسلام. « يمسهم العذاب » أي يصيبهم « بما كانوا يفسقون » أي يكفرون.
الآية: 50 ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون )
قوله تعالى: « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » هذا جواب لقولهم: « لولا نزل عليه آية من ربه » [ الأنعام: 37 ] ، فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات، ولا أعلم الغيب فأخبركم به. والخزانة ما يخزن فيه الشيء؛ ومنه الحديث ( فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته ) . وخزائن الله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون « ولا أعلم الغيب » أيضا « ولا أقول لكم إني ملك » وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل، أي لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر. واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقد مضى في « البقرة » القول فيه فتأمله هناك.
قوله تعالى: « إن أتبع إلا ما يوحى إلي » ظاهره أنه لا يقطع أمرا إلا إذا كان فيه وحي. والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد، والقياس على المنصوص، والقياس أحد أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في « الأعراف » وجواز اجتهاد الأنبياء في ( الأنبياء ) إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: « قل هل يستوي الأعمى والبصير » أي الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: الجاهل والعالم. « أفلا تتفكرون » أنهما لا يستويان.
الآية: 51 ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون )
قوله تعالى: « وأنذر به » أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقيل: « به » أي بالله. وقيل: باليوم الآخر. وخص « الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم » لأن الحجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه، لا أنهم يترددون في الحشر؛ فالمعنى « يخافون » يتوقعون عذاب الحشر. وقيل: « يخافون » يعلمون، فإن كان مسلما أنذر ليترك المعاصي، وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. قال الزجاج: كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم بيوم القيامة. والأول أظهر. « ليس لهم من دونه » أي من غير الله « شفيع » هذا رد على اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: « نحن أبناء الله وأحباؤه » [ المائدة: 18 ] والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله، فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار. ومن قال الآية في المؤمنين قال: شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله فهو الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل: « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » [ الأنبياء: 28 ] . « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » [ سبأ: 23 ] . « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [ البقرة:255 ] . « لعلهم يتقون » أي في المستقبل وهو الثبات على الإيمان.
الآية: 52 ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين )
قوله تعالى: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم » الآية. قال المشركون: ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء - يعنون سلمان وصهيبا وبلالا وخبابا - فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم بذلك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعا عليا ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم، وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا، ولا ينقص لهم قدرا، فمال إليه فأنزل الله الآية، فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا؛ قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق. ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة. « يريدون وجهه » أي طاعته، والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله، ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كما قال: « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » [ الرحمن: 27 ] وهو كقوله: « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » [ الرعد: 22 ] . وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره الله في قوله: « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم » [ الكهف: 28 ] ، فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام، وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن ماجة في سننه عن خباب في قول الله عز وجل: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » إلى قوله: « فتكون من الظالمين » قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال: ( نعم ) قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا - رضي الله عنه - ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام فقال: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن؛ فقال: « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين » [ الأنعام: 53 ] ثم قال: « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » [ الأنعام: 54 ] قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل الله عز وجل « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » [ الكهف: 28 ] ولا تجالس الأشراف « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » [ الكهف: 28 ] يعني عيينة والأقرع، « واتبع هواه وكان أمره فرطا » [ الكهف: 28 ] ، أي هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرع؛ ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب؛ وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم، قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله عز وجل: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » الآية. وقرئ ( بالغدوة ) وسيأتي بيانه في ( الكهف ) إن شاء الله.
قوله تعالى: « ما عليك من حسابهم من شيء » أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم على الله، وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. ( من ) الأولى للتبعيض، والثانية زائدة للتوكيد. وكذا « وما من حسابك عليهم من شيء » المعنى وإذا كان الأمر كذلك فاقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالما. وحاشاه من وقوع ذلك منه، وإنما هذا بيان للأحكام، ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل قوله: « لئن أشركت ليحبطن عملك » [ الزمر: 65 ] وقد علم الله منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله. « فتطردهم » جواب النفي. « فتكون من الظالمين » نصب بالفاء في جواب النهي؛ المعنى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين، وما من حسابك، عليهم من شيء فتطردهم، على التقديم والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. وقد حصل من قوة الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه، وعن أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبيه.