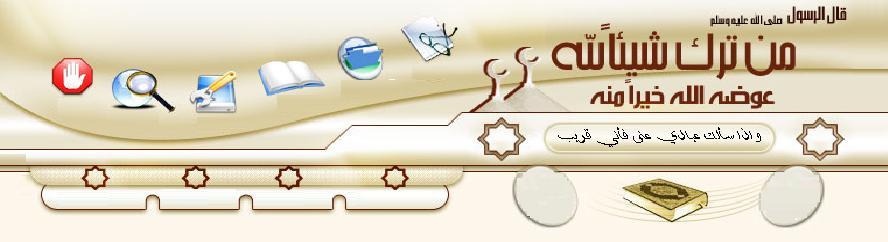سورة النور
الآية: 1 ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون )
مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: ( علموا نساءكم سورة النور ) . وقالت عائشة رضي الله عنها: ( لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل ) . « وفرضناها » قرئ بتخفيف الراء؛ أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو عمرو: « وفرضناها » بالتشديد أي قطعناها في الإنزال نجما نجما. والفرض القطع، ومنه فرضة القوس. وفرائض الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضا « فرضناها » فصلناها وبيناها. وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة؛ ولذلك سميت السورة من القرآن سورة. قال زهير:
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب
وقد مضى في مقدمة الكتاب القول فيها. وقرئ « سورة » بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها « أنزلناها » ؛ قاله أبو عبيدة والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمبرد: « سورة » بالرفع لأنها خبر الابتداء؛ لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع، أي هذه سورة. ويحتمل أن يكون قوله « سورة » ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك، ويكون الخبر في قوله « الزانية والزاني » . وقرئ « سورةً » بالنصب، على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها. وقال الشاعر:
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا
أو تكون منصوبة بإضمار فعل أي اتل سورة. وقال الفراء: هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه.
الآية: 2 ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )
قوله تعالى: « الزانية والزاني » كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا؛ فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة « النساء » باتفاق.
قوله تعالى: « مائة جلدة » هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: « فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » [ النساء: 25 ] وهذا في الأمة، ثم العبد في معناها. وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم يرجم. وقد مضى هذا كله ممهدا في « النساء » فأغنى عن إعادته، والحمد لله.
قرأ الجمهور « الزانية والزاني » بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي « الزانية » بالنصب، وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدا اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء، وتقديره: فيما يتلى عليكم [ حكم ] الزانية والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه، والخبر في قوله « فاجلدوا » لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود « والزان » بغير ياء.
ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل: ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » [ المائدة: 38 ] . ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي. فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( كفر ) . فأمره بالكفارة، والمرأة ليس بمجامعة ولا واطئة.
قدمت « الزانية » في الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكن مجاهرات بذلك. وقيل: لأن الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب فصدرها تغليظا لتردع شهوتها وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما.
الألف واللام في قول « الزانية والزاني » للجنس، وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن، وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشراحة وقد مضى في « النساء » بيانه. وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها.
نص الله سبحانه وتعالى على ما يجب على الزانيين إذا شُهد بذلك عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه: يضرب كل واحد منهما مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلى وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد على قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب. وقد مضى في « هود » اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده.
قوله تعالى: « فاجلدوا » دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء؛ وهكذا « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » [ المائدة: 38 ] .
لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد. قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.
أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين. لا شديدا ولا لينا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: ( فوق هذا ) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: ( دون هذا ) فأتي بسوط قد ركب به ولان. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد... ) الحديث. قال أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلا جميع رواة الموطأ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه، وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وقد تقدم في « المائدة » ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام. يريد وسطا.
اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى؛ فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: يجرد، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي: الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وقال الشعبي والنخعي: لا يجرد ولكن يترك عليه قميص. قال ابن مسعود: لا يحل في الأمة تجريد ولا مد وبه فال الثوري.
اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما؛ ولا يجزى عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان مده صلاحا مد.
واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر، وكذلك التعزير. وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن علي. وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى. قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس فقال الجمهور: يتقى الرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس. وضرب عمر رضي الله عنه صبيا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا. ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس، وقوله عليه السلام: ( البينة وإلا حد في ظهرك ) وسيأتي.
الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وأتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. وأتي رضي الله عنه بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحد فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة: ( أقص عنه بعشرين ) يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف.
وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير مبرح؛ ضرب بين ضربين. هو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب؛ وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال الثوري: ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف عل عدد الجلدات، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو حنيفة بفعل عمر، فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنى. احتج الثوري بأن الزنى لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت الحد إلا بالاجتهاد، وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوي قوة مسائل التوقيف.
الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك، رضي الله عنهم. وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية، تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة، فيجب مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها؛ فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها - فكأنه وجد عليه - فقال: يا عبدالله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعلي يعد... ) الحديث. وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان للإمام علي: قم فاجلده.
نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف، وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. قال ابن العربي: وهذا ما لم يتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي، حتى يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي، والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة، لمات كمدا ولم يجالس أحدا؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قلت: ولهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. وروى الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين، قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لو تأخر الهلال لزدتكم ) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. في رواية ( لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) . وروى حامد بن يحيى عن سقيان عن مسعر عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببا.
قوله تعالى: « ولا تأخذكم بهما رأفة » أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع، وهذا قول جماعة أهل التفسير. وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: « لا تأخذكم بهما رأفة » قالوا في الضرب والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة؛ ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرئ « رأفة » بفتح الألف على وزن فعلة. وقرئ « رأفة » على وزن فعالة؛ ثلاث لغات، هي كلها مصادر، أشهرها الأولى؛ من رؤوف إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكآبة. وقد رأفت به ورؤفت به. والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم. « في دين الله » أي في حكم الله؛ كما قال تعالى: « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » [ يوسف: 76 ] أي في حكمه. وقيل: « في دين الله » أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى: « إن كنتم تؤمنون بالله » . وهذا كما تقول لرجل تحضه: إن كنت رجلا فافعل كذا، أي هذه أفعال الرجال.
اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود بها الإغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس، وأن ذلك يدع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؛ قولان للعلماء.
روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما اللواتي الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار ) . وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعمال أمتي تعرض علي كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة ) . وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا خمسة ساحرا أو كاهنا أو عاقا لوالديه أو مدمن خمر أو مصرا على الزنى ) .
الآية: 3 ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )
اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله « لا ينكح » أي لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذا كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن « حتى تنكح زوجا غيره » [ البقرة: 230 ] وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، وقد تقدم في « البقرة » . وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس، وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية، ويفيد أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول.
الثاني: ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله؛ أنكح عناق؟ قال: فسكت عني؛ فنزلت « والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » ؛ فدعاني فقرأها علي وقال: ( لا تنكحها ) . لفظ أبي داود، وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.
الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاصي ومجاهد.
الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قال ابن أبي صالح.
الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدو والزانية المحدودة، قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله ) . وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة.
قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين، وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك؛ وهذا في غاية البعد، وهو خروج عن الإسلام بالكلية، وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية.
السادس: أنها منسوخة؛ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » قال: نسخت هذه الآية التي بعدها « وأنكحوا الأيامى منكم » [ النور: 32 ] ؛ وقاله ابن عمرو، قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنى من كل جهة، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني.
في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. وسيأتي.
روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة، ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة.
قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله عليه السلام: ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . قال ابن خويز منداد. وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.
قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح.
قوله تعالى: « وحرم ذلك على المؤمنين » أي نكاح أولئك البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهرهن عناق.
حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرت بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » [ النور: 2 ] .
الآيتان: 4 - 5 ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )
هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القذفة عاما لا في تلك النازلة. وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف، وظاهر كتاب الله تعالى مستغنى به دالا على القذف الذي يوجب الحد، وأهل العلم على ذلك مجمعون.
قوله تعالى: « والذين يرمون » يريد يسبون، واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول كما قال النابغة:
وجرح اللسان كجرح اليد
وقال آخر:
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني
ويسمى قذفا ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء؛ أي رماها.
ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك. وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه، ونحو ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزهراوي أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم الرجال والنساء، ويدل على ذلك قوله: « والمحصنات من النساء » . [ النساء: 24 ] . وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كما قال تعالى: « والتي أحصنت فرجها » [ الأنبياء: 91 ] فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف علها قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ الجمهور « المحصنات » بفتح الصاد، وكسرها يحيى بن وثاب. والمحصنات العفائف في هذا الموضع. وقد مضى في « النساء » ذكر الإحصان ومراتبه. والحمد لله.
للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف، وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان في الشيء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنى واللواط أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. وخمسة من المقذوف وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفا من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذابة بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنى.
اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد فإن عرض ولم يصرح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفا حتى يقول أردت به القذف. والدليل لما قال مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعرض وجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعول على الفهم وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب: « إنك لأنت الحليم الرشيد » [ هود: 87 ] أي السفيه الضال فعرضوا له بالسب بكلام ظاهر المدح في أحد التأويلات، حسبما تقدم في « هود » . وقال تعالى في أبي جهل: « ذق إنك أنت العزيز الكريم » [ الدخان: 49 ] . وقال حكاية عن مريم: « يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » [ مريم: 28 ] ؛ فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، أي الزنى، وعرضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: « وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما » [ النساء: 156 ] ، وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: « قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » [ سبأ:24 ] ؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى، وأن الله تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ولما سمع قول النجاشي:
قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير.
الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد. قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلافا.
والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى. وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد ثمانين. وجلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حرا ثمانين؛ وبه قال الأوزاعي. احتج الجمهور بقول الله تعالى: « فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » [ النساء: 25 ] . وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى، وأنه ربما كان أخف فيمن قلّت نعم الله عليه، وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر من الزنى. قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول.
وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ولقوله عليه السلام: ( من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض طرقه: ( من قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم عليه بوم القيامة الحد ثمانون ) ذكره الدارقطني. قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم العليم، لا إله إلا هو.
قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد؛ وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أم الولد حد وروى عن ابن عمر وهو قياس قول الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حد عليه.
واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطئ بين الفخذين؛ فقال ابن القاسم: عليه الحد لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه لأنه نسبة إلى فعل لا يعد زنى إجماعا.
الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها، ويعزر. قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك كذب، ويعزر على الأذى. قال أبو عبيد: في حديث علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال: إن كنت صادق رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته الحد.
وفيه أيضا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد؛ ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي وبما يقول، فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله.
وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده؛ لأنه لا يدري لعله يصدقه؛ ألا ترى أن عليا عليه السلام لم يعرض لها.
وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحد بسماعه ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك وهذا لأنه من حقوق الناس.
قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؛ وسيأتي. قال أبو عبيد: قال الأصمعي سألني شعبة عن قول: غيرى نغرة؛ فقلت له: هو مأخوذ من نغر القدر، وهو غليانها وفورها يقال منه: نغرت تنغر، ونغرت تنغر إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما تريد. قال: ويقال منه رأيت فلانا يتنغر على فلان أي يغلي جوفه عليه غيظا.
من قذف زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حد حدين؛ قاله مسروق. قاله ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله تعالى: « والذين يرمون المحصنات » الآية، ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن؛ لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود، ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن قذف عائشة رضي الله عنها، هل يقتل أم لا.
قوله تعالى: « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى؛ رحمة بعباده وسترا لهم. وقد تقدم في سورة « النساء »
من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك في مجلس واحد فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبدالملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبدالملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عثمان البتي وأبي ثور واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » وقوله: « فإذ لم يأتوا بالشهداء » [ النور: 13 ] ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين.
فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصري والشعبي يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم مسقوطا عليه أو عبدا يجلدون جميعا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون.
فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنى؛ فقالت طائفة: يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن قال عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية، وعليه الحد. وقال الحسن البصري: يقتل، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة، وإن قال تعمدت قتل وبه قال ابن شبرمة.
واختلف العلماء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبي حنيفة. والثاني: قول مالك والشافعي. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا له تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنى. وإن كان حقا للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه، ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف.
قوله تعالى « بأربعة شهداء » قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى الشهداء. وقرأ عبدالله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير « بأربعة » التنوين « شهداء » . وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة، أو بدلا. ويجوز أن يكون حالا من نكرة أو تمييزا؛ وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة، والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أنه تنوين العدد، وترك إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد حسن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة وحبب على قراءة الجمهور. قال النحاس: ويجوز أن يكون « شهداء » في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء.
حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود في المكحلة على ما تقدم في « النساء » في نص الحديث. وأن تكون في موطن واحد؛ على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كما فعل عمر في أمر المغيرة بن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال الزهراوي: عبدالله بن الحارث، وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية، وشبل بن معبد البجلي، فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدها، جلد عمر الثلاثة المذكورين.
قوله تعالى: « فاجلدوهم » الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن الخطيم:
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف محراق لاعب
« ثمانين » نصب على المصدر. « جلدة » تمييز. « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » هذا يقتضي مدة أعمارهم، ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله عز وجل.
قوله تعالى: « إلا الذين تابوا » في موضع نصب على الاستثناء. ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. المعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف « فإن الله غفور رحيم » . فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدا، وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع؛ إلا ما روي الشعبي على ما يأتي. وعامل في فسقه بإجماع. واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده، وهو قول عامة الفقهاء. ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وغيره، أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. وهكذا فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة - منها مالك رحمه الله تعالى وغيره - : توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة، إذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء؛ وقد قال الله عز وجل: « وإني لغفار لمن تاب » [ طه: 82 ] الآية.
اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف، وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته.
واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا؛ وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء؛ رواه نافع وابن عبدالحكم عن مالك، وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة، وتقبل فيما سوى ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون. وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. قال سحنون: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى، ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا؛ وروياه عن مالك. واتفقوا على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى.
الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما. وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق؛ ولهذا لا تقبل شهادته، فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة.
وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها، أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك، وهو الصحيح في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض، على ما يعرف من النحو.
السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة، فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء، أو لا يشبه به، لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح، فتعين ما قال القاضي من الوقف. ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق، وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق، وآية القذف محتملة للوجهين، فتعين الوقف من غير مين. قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر، فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة؛ قال: وليس من نسب إلى الزنى بأعظم جرما من مرتكب الزنى، ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » [ المائدة: 33 ] إلى قوله « إلا الذين تابوا » [ المائدة:34 ] . ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله « أبدا » أي ما دام قاذفا؛ كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا؛ فإن معناه ما دام كافرا. وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: « وأولئك هم الفاسقون » تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم. ثم توبة القاذف إكذابه نفسه، كما قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير، مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة، ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبدا، ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولهم، والله المستعان.
قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان، أو عفا المقذوف، فالشهادة مقبولة؛ لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد؛ قال الله تعالى: « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » . وعند هذا قال الشافعي: هو قبل أن يحد شر منه حين حد؛ لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه دون أخسهما.
قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته. وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحد؛ لأنه بالقذف يفسق، لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه.
قوله تعالى: « وأصلحوا » يريد إظهار التوبة. وقيل: وأصلحوا العمل. « فإن الله غفور رحيم » حيث تابوا وقبل توبتهم.
الآيات: 6 - 10 ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم )
قوله تعالى: « ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » « أنفسهم » بالرفع على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء، وعلى خبر « يكن » . « فشهادة أحدهم أربع شهادات » بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو « أربع » بالنصب؛ لأن معنى « فشهادة » أن يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. « والخامسة » رفع بالابتداء. والخبر « أن » وصلتها؛ ومعنى المخففة كمعنى المثقلة لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبدالرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص « والخامسة » بالنصب، بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة. الباقون بالرفع على الابتداء، والخبر في « أن لعنة الله عليه » ؛ أي والشهادة الخامسة قول لعنة الله عليه.
في سبب نزولها، وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النبي